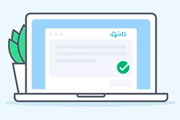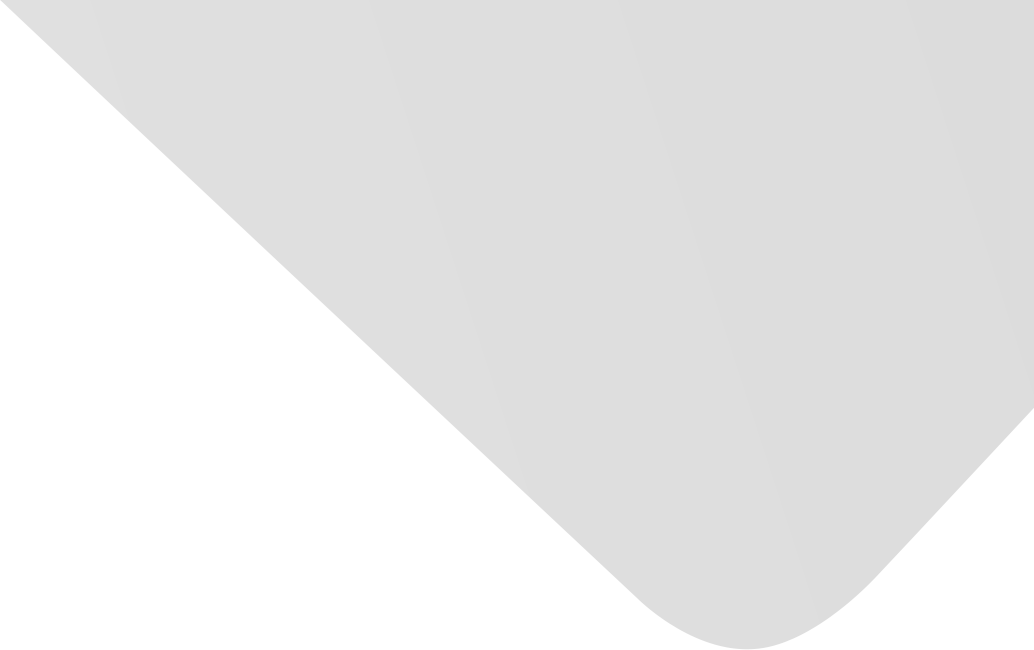
النظام السياسي و المشاركة السياسية للأحزاب في الأردن : دراسة في انتخابات 1993
العناوين الأخرى
The political system and the political participation of political parties in Jordan : a study of 1993 elections
مقدم أطروحة جامعية
مشرف أطروحة جامعية
أعضاء اللجنة
المصالحة، محمد حمدان
الرشدان، عبد الفتاح علي السالم
عطا الله، حمدي عبد الرحمن حسن
الجامعة
جامعة آل البيت
الكلية
معهد بيت الحكمة
دولة الجامعة
الأردن
الدرجة العلمية
ماجستير
تاريخ الدرجة العلمية
1999
الملخص العربي
هدفت هذه الدراسة إلى بيان العلاقة بينا لنظام السياسي الأردني و المشاركة السياسية للأحزاب في انتخابات عام ١٩٩٣ النيابية، و تنبع أهميتها من اعتبارين رئيسيين و هما : الاعتبار العلمي، و الاعتبار العملي، أما الاعتبار العلمي فيتمثل في آن هناك أدبيات ركزت في مفاهيم النظام السياسي و الأحزاب السياسية و المشاركة السياسية و الانتخابات، و دراسة هذه المفاهيم في التجربة السياسية الأردنية و خاصة بعد الأخذ بالتحول الديمقراطي سيكشف إلى أي مدى تتميز هذه التجربة بخصوصية واضحة في التعامل مع هذه الفاهيم، كما أن دراسة الخبرة السياسية الآردنية يجب اعتبارها على أنها عملية ممتدة، و بالتالي فإن التوقف عند أي مرحلة من مراحلها لا يعني تجاوز المرحلة السابقة أو اللاحقة للمرحلة موضوع الدراسة، و إنما تفترض الدراسة العلمية ضرورة الربط بين كل مراحل الخبرة السياسية الأردنية بشكل أو آخر و هو ما سعت الدراسة إلى توكيده رغم التركيز على مرحلة التطور السياسي في انتخابات 1993، و مما يزيد في أهمية الدراسة، أن التجربة الحزبية الأردنية مرت بتطورات كثيرة تراوحت بين المشاركة السياسية و بين حظر هذه المشاركة لاعتبارات كثيرة، ومن ثم يجب التوقف عند الدراسة و التحليل لأسباب المشاركة، بأسباب حظرها، و إذا كانت تجربة انتخابات ١٩٩٣ جاءت تجسيد للتطور نحو المزيد من المشاركة، فإن التوقف عند الدراسة و التحليل هذه التجربة، و علاقتها بالنظام السياسي من الأهمية بمكان نحو تدعيم الانفراج الديمقراطي و تكريسه، كما أشار جلالة الملك الحسين في أكثر من مناسبة. أما الأهمية العملية للدراسة، فتتمثل في انها تحاول كشف المعابر و أسباب فعالية المؤسسات السياسية الأردنية الرسمية و غير الرسمية في مرحلة التحول الديمقراطي، كما ظهرت في انتخابات 1993، التي أظهرت استعدادا واضحا لدى كل من النظام السياسي الأردني، و الأحزاب السياسية الأردنية نحو تفعيل التحول الديمقراطي و هو ما ينبغي الحرص عليه و تفعيله بعد انتخابات 1993، كما أنها تحاول أن تبين مدى سعي النظام السياسي الأردني إلى توكيد فعالية المشاركة السياسية للأحزاب في عملية صنع القرار، و تؤكد في الوقت ذاته على ضرورة أن تسهم الأحزاب السياسية الأردنية بما يتيح لها الدستور،و بما تقتضيه المصالح القومية للوطن في أن تقوم بواجباتها نحو هذه المسؤولية، و التي أخذها النظام السياسي على عاتقه بحيث تكون مؤسسات فاعلة و ايجابية، و ليست مجرد هياكل شكلية بلا فاعلية، و من منابع الأهمية العملية لهذه الدراسة، أن موضوعها إذا كان يقدم تحليلا لعلاقة النظام السياسي بالمشاركة السياسية للأحزاب، فإن هذا التحليل يستلزم و يتطلب من الدارسين النظر في علاقات أخرى للنظام السياسي الأردني، مثل النقابات و غيرها من مؤسسات المجتمع المدني، بل و دراسة علاقات الأحزاب بهذه المؤسسات، و ذلك سعيا إلى أن تؤدي كل مؤسسات المجتمع دورها الحقيقي في المشاركة في عملية التحول الديمقراطي الأردني. و أشارت مشكلة الدراسة إلى أنه بصدور قانون الأحزاب السياسية رقم (32) لسنة 1992، و قانون الانتخابات المؤقتة لسنة 1993، أجريت انتخابات 1993 السياسية على أساس التعددية الحزبية بعد حظر استمر منذ عام 1957، و هذه الدراسة تحاول الإجابة على سؤال محوري هو : ما هي طبيعة العلاقة بين دور النظام السياسي الأردني و بين المشاركة السياسية للأحزاب السياسية الأردنية في انتخابات عام ١٩٩٣ النيابية ؟ و يتفرع هن هذا السؤال المحوري الأسئلة التالية : 1- إلى أي مدى أثرت بيئة النظام السياسي الأردني الداخلية و الخارجية على دوره في المشاركة السياسية للأحزاب السياسية في انتخابات 1993 ؟ 2- إلى أي مدى استطاع النظام السياسي ممارسة تأثيره في إدارة العملية الانتخابية في عام ١٩٩٣ بالنسبة إلى الأحزاب السياسية التي شاركت فعليا فيها ؟ 3- في أي مراحل العملية الانتخابية مارس النظام السياسي تأثيره على مشاركة الأحزاب فيها ؟ و ما هي الأساليب التي اتبعها في ذلك. 4- ما هي نتائج تأثر المشاركة السياسية للأحزاب في انتخابات ١٩٩٣ باستخدام النظام لهذه الأساليب؟. و تنطلق الدراسة في محاولة الإجابة على التساؤل الرئيسي السابق من فرضية مؤداها : 1- هناك علاقة عكسية بين تأثير البيئة الداخلية و الخارجية على النظام السياسي الأردني، و بين مشاركة الأحزاب السياسية الأردنية في العملية الانتخابية في 1993. 2- هناك علاقة عكسية بين دور النظام السياسي في مقدمات العملية الانتخابية، و بين مشاركة الأحزاب السياسية في هذه المقدمات. 3- هناك علاقة عكسية بين دور النظام السياسي في عمليات التصويت في انتخابات 1993، و بين مشاركة الأحزاب في هذا التصويت. 4- هناك علاقة عكسية بين دور النظام السياسي في عملية فرز أصوات انتخابات 1993، و بين النتائج التي حصلت عليها الأحزاب بموجب هذه العملية. و تم في هذه الدراسة تحديد مفاهيمها الرئيسية من خلال الأدبيات السياسية، حيث تم تحديد مفهوم كل من النظام السياسي، الأحزاب السياسية، المشاركة السياسية، الانتخاب. و حتى تصل الدراسة إلى إجابات واضحة على تساؤلاتها فقد استخدم الباحث منهج تحليل النظم و يقتضي الحديث عن منهاجية الدراسة توضيح ثلاثة أمور أخذها الباحث في الاعتبار، الأمر الأول خاص بالأسباب التي دعته إلى استخدام منهج تحليل النظم، والثاني متعلق بالمقولات الأساسية باختصار لهذا المنهج، و الثالث مرتبط بكيفية استخدامه في هذه الدراسة. ففيما يتعلق بالأمر الأول، فقد انطلق الباحث في الاعتماد على منهج تحليل النظم لأنه يساعد في بيان كيف يتعامل النظام مع المدخلات و المخرجات و العلاقات فيما بينهما، و كيف يتكيف مع البيئة، و ما هي أنواع سلوكياته التي تؤدي إلى بناء النظام و تلك التي تؤدي إلى ضعفه أو تدهوره، فهو يأخذ النظام كوحدة تحليل، و ينظر إليه على أنه تفاعل بين عناصر معينة. و فيما يتعلق بالأمر الثاني، فمنهج تحليل النظام يفترض أن الظواهر السياسية يمكن أن يتم تحليلها من خلال النظر إليها على أنها أجزاء من كيان كلي نظامي، و أن لكل نظام عناصر يمكن تحديدها تبعا لنطاق النظام، كما أنه يتطلب وجود علاقات بين عناصره و ليس مجرد وجود تلك العناصر فهي تتفاعل فيما بينها و يعتمد الواحد منها على الآخر. و قدم ايستون إطارا عاما لتحليل النظام السياسي، يتمثل بوجود مدخلات تؤثر على النظام و مخرجات تتعلق بتأثيرات النظام على البيئة : كالقرارات و السياسات التي تصدر عن النظام لتلبية المطالب التي تنتج عن تأثيرات البيئة، إضافة إلى آن هناك تغذية عكسية تبين نتائج أفعال النظام، و تلعب دورا في بيان مدى تأثير المخرجات على المدخلات و بالتالي على القرارات و فيها يتعلق بكيفية استخدام هذا النهج في الدراسة فإن الباحث سيحاول دراسة البيئة المحيطة بالنظام سواء أكانت داخلية أم خارجية، و سيتم التركيز على الأوضاع التشريعية كالدستور 1952 و قوانين الأحزاب و الانتخاب و الأوضاع السياسية و الاقتصادية، و التي يمكن اعتبارها مدخلات شكلت بيئة عامة للنظام، لبيان مدى استبانة هذا النظام لهذه البيئة و مخرجاته المتعلقة بالتحول الديمقراطي و تنظيم المشاركة السياسية للأحزاب في انتخابات عام ١٩٩٣، ويعتبر الباحث النظام السياسي النسق الرئيسي و بأنه يضم انساقا فرعية كالسلطة التنفيذية و الأحزاب السياسية و هي المؤسسات المعنية في هذه الدراسة. و قد حاولت الدراسة الاستعانة بمجموعة من الدراسات التي تناولت النظام السياسي بشكل عام من حيث مدخلاته و مخرجاته، و اعتبرت هذه الدراسات النظام وحدة التحليل، و بأنه يتكون من أبنية سياسية رسمية و غير رسمية و تقوم بوظائف معينة، و مثل هذه الدراسات تفيد الباحث في فهم البيئة المحيطة بالنظام. و كذلك الدراسات التي تناولت قضايا التحول الديمقراطي في النظام السياسي الأردني كانتخابات عام 1993 موضوع الدراسة، و الدراسات التي تناولت النظام السياسي الأردني، و التجربة الحزبية في الأردن، و كما هو مبين في مقدمة الدراسة. و يرى الباحث أن هذه الدراسات ستفيده في دراسته لما احتوته من معلومات أولية. أما الفصل الثاني فكان بمثابة تحليل دور النظام و علاقته بمشاركة الأحزاب السياسية، و تم تحديد انتخابات عام 1993 كحالة لهذا التحليل حيث أنها أول انتخابات جرت على أساس حزبي منذ حظر العمل الحزبي عام 1957، و تركز التحليل على معرفة دور النظام و الأحزاب و العلاقة بينهما في فعاليات و مراحل العملية الانتخابية، كالتسجيل في جداول الناخبين، و الترشيح للانتخابات و الدعاية، و التصويت، و فرز النتائج.
و تبين في هذا الفصل أن النظام السياسي قبل التعددية السياسية بجميع أطيافها بدليل عدم رفض ترخيص الأحزاب التي تقدمت للترخيص، كما تبين أن مؤسسة العرش لم تتدخل في تلك الانتخابات و هذا يحمل في طياته دلالات ذات مغزى، حيث أكدت مصداقية قيادة النظام في تبني الديمقراطية، كما تبين بأن النظام السياسي لم يتدخل في مقدمات العملية الانتخابية، باستثناء تدخله في مرحلة الدعاية كمنعه الخطابات و المهرجانات الانتخابية، كما لوحظ انه لم تشارك كافة الأحزاب في العملية الانتخابية، حيث أعلن بعضها عن مشاركة بينما لم تعلن أحزاب أخرى عن مشاركتها لاعتمادها على القواعد العشائرية، و لوحظ أيضا أن المشاركة الحزبية كانت ضعيفة في تلك الانتخابات مع أن النظام لم يرفض مشاركة أي حزب أو مرشح في الانتخابات، و مع انه كانت هناك حالات رفض ترشيح لبعض المرشحين، إلا انه لوحظ أن القضاء أن القضاء حكم بإلغاء بعض قرارات وزارة الداخلية في منع بعض المرشحين من الترشيح و التزمت الحكومة بحكم القضاء، و هذا يدل على مدى استقلال السلطة القضائية ودورها في تلك الانتخابات، و مدى التزام السلطة التنفيذية بتلك القرارات. و لوحظ أيضا أن أحزاب الوسط شاركت في الانتخابات بطريقة غير مباشرة، حيث أوعزت لمرشحيها بخوض الانتخابات اعتمادا على قواعدهم العشائرية و ليس الحزبية، و هذا يحمل في طياته دلالة على أن القواعد العشائرية ما زالت أقوى من القواعد الحزبية في المجتمع السياسي الأردني، بدليل حصول أحزاب الوسط و المستقلين على أغلبية المقاعد، بينما حصلت الاتجاهات الحزبية الأخرى على نسب ضئيلة، كما بينته نتائج تلك الانتخابات.
و لوحظ أيضا أن أساليب مشاركة الأحزاب السياسية في مقدمات العملية الانتخابية تركزت حول المشاركة في الترشيح و كانت ضعيفة، و الاحتجاجات و البيانات الصحفية الموجهة ضد ممارسات النظام خاصة منعه المهرجانات و الخطابات،و لم يلاحظ أن الأحزاب السياسية قد نظمت اعتصامات، أو قامت بأحداث عنف أو مظاهرات في هذه المرحلة. كما لوحظ أن النظام السياسي لم يتدخل في مرحلة التصويت بشكل مباشر، إلا أن تقسيمه للدوائر الانتخابية، و توزيعه للمقاعد و صنادق الفرز لم تكن عادلة، و فسر ذلك بأنه تدخل من قبل النظام السياسي نقدته الأحزاب السياسية بشدة من خلال بياناتها و احتجاجاتها الصحفية، و بررت معظم أحزاب اليسار و حزب جبهة العمل الإسلامي ضعف النتائج بقانون الانتخاب، الذي نقدته تلك و للوصول إلى الحقائق فقد قسم الباحث هذه الرسالة إلى مقدمة و فصلين و خاتمة، تناولت المقدمة أهمية الدراسة، و مشكلتها،و أهدافها، و فرضياتها، و النهج الذي استخدمته، و مفاهيمها، و الدراسات السابقة، أما الفصل الأول فقد تناول البيئة العامة للنظام السياسي الأردني و للمشاركة السياسية للأحزاب في الانتخابات البرلمانية لعام 1993، حيث تم عرض عام للتطور الدستوري للنظام السياسي الأردني، و تطور قوانين تنظيم العمل السياسي الحزبي في الأردن، قوانين، تنظيم العمل السياسي الحزبي في الأردن، بذلك لمعرفة إلى أي مدى ضمنت هذه الدساتير و القوانين حرية العمل السياسي في الأردن، و كذلك تحديد ملامح النظام السياسي التي تدور في فلكه الأحزاب السياسية الأردنية، كما تناول هذا الفصل طبيعة البيئة السياسية للعملية الانتخابية، كأحداث الجنوب، و انتخابات عام ١٩٨٩، و إلغاء القوانين و الإجراءات التي أعاقت الديمقراطية لفترة من الزمن في الحياة السياسية الأردنية، و البيئة و التطورات الخارجية و التي تزامنت و انتخابات ١٩٩٣ في الأردن. و قد تبين من خلال هذا الفصل أن النظام السياسي الأردني عرف التجربة الحزبية منذ بدايات نشأة الدولة الأردنية، حيث نمى القانون الأساسي الذي يعتبر أول دستور للنظام السياسي الأردني على حرية الاجتماع، و ضمنت بعد ذلك كافة الدساتير اللاحقة و خاصة دستور 1952 و هو المعول به حاليا تلك الحرية، و تأكيد للأحكام الدستورية الضامنة لهذه الحرية فقد قام النظام السياسي بإصدار مجموعة من القوانين ذات العلاقة بالعمل الحزبي السياسي لتنظيمها و حمايتها، بالرغم من انه حدث في مرحلة عن مراحل تطبيق النظام السياسي الأردني حالة تم خلالها حظر النشاط الحزبي لفترة طويلة من الزمن، أنه تبين أن النظام السياسي الأردني نو جذور ديمقراطية حيث عاد و أعلن ضرورة تكريس العمل الديمقراطي في الحياة السياسية. كما تبين في هذا الفصل أن هناك عوامل ساهمت بشكل مباشر أو غير مباشر في إسراع النظام السياسي الأردني نحو تحقيق التحول الديمقراطي، كأحداث الجنوب، و الأوضاع الاقتصادية و التحولات في النظام الدولي حيث استوعب النظام هذه الأحداث بشكل إيجابي و انعكس ذلك على التوجه الديمقراطي للنظام السياسي الأردني. كما تبين أيضا أن القيادة و الممثلة بالملك الحسين بن طلال كانت السبب المباشر في إحداث هذا التحمل، حيث تمتعت هذه القيادة بقدرات فائقة على استيعاب كافة الظروف و الأحداث، و تبنت التوجه الديمقراطي للنظام، و كانت انتخابات عام 1989 و 1993 و إلغاء كافة القوانين و الأنظمة و الإجراءات المعيقة للعمل الديمقراطي من نتائج هذا التوجه. و انتهى هذا الفصل إلى أن هناك عوامل كثيرة شكلت البيئة التي جرت في ظلها العملية الانتخابية.
و أن هذه العوامل فرضت تأثير بشكل أو أخر على النظام و على الأحزاب. الأحزاب، هذا النقد لم يخرج عن إطار البيانات و الاحتجاجات الصحفية و مطالبة الحكومة بالعدول عن هذا القانون، لأنه يمزق المجتمع الأردني، و يقلل فرص إجراء التحالفات بين المرشحين وبين الأحزاب. و خلص هذا الفصل إلى آن تدخل النظام السياسي في العملية الانتخابية لم يكن تدخل مباشرا، و في جميع مراحل العملية الانتخابية باستثناء أنه كان هناك تدخل في منع الخطابات و المهرجانات الانتخابية، و قد تبين أن الحكومة قد تراجعت عن ذلك المنع، و إن دل ذلك على شيء فإنما يدل على مدى تأثر النظام السياسي و استجابته للاحزاب، كما تدخل النظام أيضا في منع بعض المرحين من الترشيح، إلا أن القضاء حكم بإلغاء بعض قرارات الحكومة و التزمت الحكومة بقرار القضاء.
كما تدخل في توزيع البطاقات الانتخابية التي جاء فيها تكرار كبير، و تعقيدات في عمليات التسجيل سبق و أن أشارت إليها الأحزاب و طالبت الحكومة بضرورة تبسيط إجراءاتها، إلا أنه يلاحظ أن الحكومة لم تخرج عن إطار التعليمات الواردة في إطار الانتخاب المتعلقة بإجراءات السجيل، و بالتالي لا يرى الباحث أن النظام السياسي تدخل في هذه المرحلة فلم تخرج ممارساته عن الإطار الذي حدده القانون.
التخصصات الرئيسية
الموضوعات
عدد الصفحات
203
قائمة المحتويات
فهرس المحتويات / الموضوعات.
الملخص / المستخلص.
المقدمة.
الفصل الأول : البيئة العامة للنظام السياسي الأردني و المشاركة السياسية الحزبية في الانتخابات البرلمانية 1993.
الفصل الثاني : النظام السياسي الأردني و الأحزاب السياسية و فعاليات العملية النتخابية في 1993.
الخاتمة.
قائمة المراجع.
نمط استشهاد جمعية علماء النفس الأمريكية (APA)
القاضي، عادل تركي سعود. (1999). النظام السياسي و المشاركة السياسية للأحزاب في الأردن : دراسة في انتخابات 1993. (أطروحة ماجستير). جامعة آل البيت, الأردن
https://search.emarefa.net/detail/BIM-319091
نمط استشهاد الجمعية الأمريكية للغات الحديثة (MLA)
القاضي، عادل تركي سعود. النظام السياسي و المشاركة السياسية للأحزاب في الأردن : دراسة في انتخابات 1993. (أطروحة ماجستير). جامعة آل البيت. (1999).
https://search.emarefa.net/detail/BIM-319091
نمط استشهاد الجمعية الطبية الأمريكية (AMA)
القاضي، عادل تركي سعود. (1999). النظام السياسي و المشاركة السياسية للأحزاب في الأردن : دراسة في انتخابات 1993. (أطروحة ماجستير). جامعة آل البيت, الأردن
https://search.emarefa.net/detail/BIM-319091
لغة النص
العربية
نوع البيانات
رسائل جامعية
رقم السجل
BIM-319091

قاعدة معامل التأثير والاستشهادات المرجعية العربي "ارسيف Arcif"
أضخم قاعدة بيانات عربية للاستشهادات المرجعية للمجلات العلمية المحكمة الصادرة في العالم العربي

تقوم هذه الخدمة بالتحقق من التشابه أو الانتحال في الأبحاث والمقالات العلمية والأطروحات الجامعية والكتب والأبحاث باللغة العربية، وتحديد درجة التشابه أو أصالة الأعمال البحثية وحماية ملكيتها الفكرية. تعرف اكثر