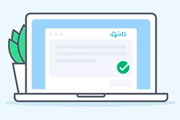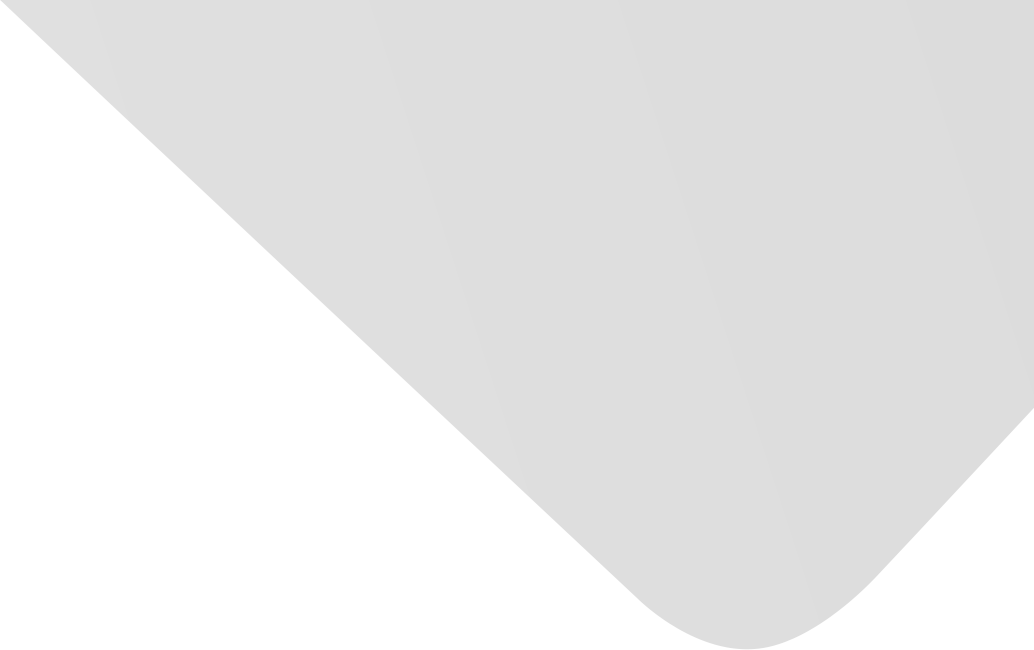
القضايا النقدية في كتابي دلائل الإعجاز و أسرار البلاغة لعبد القاهر الجرجاني
مقدم أطروحة جامعية
مشرف أطروحة جامعية
الجامعة
جامعة أم درمان الإسلامية
الكلية
كلية اللغة العربية
القسم الأكاديمي
قسم الدراسات الأدبية و النقدية
دولة الجامعة
السودان
الدرجة العلمية
ماجستير
تاريخ الدرجة العلمية
2010
الملخص العربي
استهل الباحث بحثه هذا بالتمهيد، فتناول فيه ـ بنوع من الاقتضاب في الحديث ـ علاقة النقد الأدبي بعلم البلاغة، أهما شيء واحد ذو اسمين، أم هما شيئان مختلفان لكل منهما مجاله وغايته؟ ثم تناول ـ بإيجاز واختصار ـ بدايات النقد عند العرب، ورأى من خلال ذلك التناول الموجز والمختصر أن البداية في هذا الشأن كانت انطباعية صرفا؛ إذ كان الشاعر يخرج بنتاج قريحته على الناس، فيستقبلونه بالترحاب والإيجابية تارة، وبالسخط والسلبية تارة أخرى. وفي الوقت نفسه رأى أن ذلك النقد الانطباعي كان قد بدأ في وقت مبكر من تاريخ الأدب العربي، وأن القارئ سيجد ـ إذا تتبع ـ نماذج منه عريقة في القدم. ثم انتقل الباحث إلى الحديث عن النقد في مراحل بلوغه سن الرشد حين تناولته الأقلام بالتأليف والتدوين. وكانت البداية في ذلك بأقدم من قدم دراسة في الشعر ونقده، ألا وهو ابن سلام الجمحي، ثم بأشهر المؤلفين في هذا المجال إلى عصر الإمام عبد القاهر. عندئذ تناول الباحث ترجمة هذا الإمام بنوع من الإيجاز والاختصار؛ إذ كان القصد هو إلقاء الضوء ـ فقط ـ على نذر يسير مما يتعلق بحياته العلمية. ووجهة نظر الباحث في ذلك أن معرفة هذا الإمام الجليل حق المعرفة لا تكون من خلال الوقوف على ترجمته هنا وهناك، وإنما تكون بقراءة كتابيه العظيمين: الدلائل والأسرار. ووجد ـ عندئذ ـ الفرصة سانحة ليقدم ـ لمن أراد ذلك ـ نصحا مضمونه أن عليه أن يتمكن من أداته ـ قبلُ ـ ثم يقرأ الكتابين بهدوء وتمهل، وتدبر وتأمل؛ ليتجلى له ـ حينئذ ـ الإمام عبد القاهر الجرجاني بفكره العميق، وعلمه الواسع، وذوقه المرهف، وأسلوبه الرصين. انتقل الباحث بعد ذلك إلى فصل قضية اللفظ والمعنى ـ وهو الفصل الأول في هذا البحث ـ فتناول في المبحث الأول منه نشأة هذه القضية, وأطوارها موافقا الذين رأوا أن القرن الثالث الهجري كان هو عهد إثارة هذه القضية، وأن الجاحظ كان أول من أثارها بين النقاد إثارة واسعة. وفي رأي الباحث أن بشر بن المعتمر كان سابقا للجاحظ بالكلام في هذه القضية، غير أن كلامه فيها كان عابرا لم يَرْقَ إلى مستوى الإثارة الواسعة. وفي رأي الباحث ـ أيضا ـ أن لهذه القضية أطوارا، وأن إثارة الجاحظ لها يمثل أحد هذه الأطوار، بل أولها، وأن ابن قتيبة يتزعّم الطور الثاني لها بتقسيمه الرباعي المعروف عند أهل هذا الشأن، وأن قدامة بن جعفر قد اقتفى أثر بن قتيبة في ذلك التقسيم بطريقة مختلفة نوعا ما، لا ترقى لأن تكون طريقة مذهب جديد في هذا الصدد. و من ثم بدا للباحث أن ابن طباطبا هو الذي جاء بطور ثالث و جديد؛ إذ كانت رؤيته في القضية تتلخص في أن اللفظ و المعنى ممتزجان بعضهما ببعض امتزاج الروح بالجسد، و رأى الباحث أن مذهب ابن رشيق فيما بعد كان هو نفسه مذهب ابن طباطبا، لا يختلف عنه في قليل أو كثير. ثم جر الحديث-في ذلك-الباحث إلى أبي هلال العسكري الذي كان-هو الآخر-زعيما-في نظر الباحث-لطور رابع للفظ و المعنى بتفريقه إياهما، و الحديث عن كل منهما على حدة. كان ذلك كله بمثابة سلم للصعود إلى ما أضافه الإمام عبد القاهر لهذه القضية من آراء و أفكار، فكان من الطبيعي أن يكون المبحث الثاني من هذا الفصل معقودا ليتكفل بتناول آراء الإمام عبد القاهر و أفكاره التي أسهم بها في هذه القضية. و بادئ ذي بدء استعرض الباحث ردود الإمام عبد القاهر على اللفظيين و المعنويين جميعا، ثم عرج إلى الحديث عن المعنى عند هذا الإمام، و رأى أن المعنى عنده قسمان اثنان : المعنى العام، و المعنى الخاص، و أن الأول هو المعول عليه في الفضل الذي يعرض للكلام، لا على صريح اللفظ، موردا في ذلك أدلة الإمام عبد القاهر الذي تفيد ذلك، تلك الأدلة التي تخاطب العقل، و تناجي الوجدان، و تربي ملكة الذوق البلاغي و الأدبي لدى المتلقين المتدبرين. و أما القسم الثاني، فلا دخل له في فضل الكلام و مزيته عند الإمام.
و قد أورد الباحث خلال ذلك الأدلة التي تفيد وجود ذلك التقسيم، و تثبت صحته، و تؤيد الباحث فيما ذهب إليه. و في رأي الباحث أن الإمام عبد القاهر في ذلك كله كالجاحظ تماما، فليس بينهما فرق و لا تباين؛ فما دعا الجاحظ إلى إطلاق قوله المشهور في المعاني إلا بيتان من الشعر تضمنا معنى نادرا و غريبا هو الحكمة أو شبهها، و لم يكن لهما حظ من جودة السبك و الصياغة، و لا نصيب من حسن التأليف و النظم. و من ثم رأى الباحث أن ذلك القول صدر من الجاحظ لهذا السبب، و أنه ينبغي أن يحصر في إطار سببه و لا يعمم. ثم نقل الباحث حديثه إلى معنى المعنى عند الإمام عبد القاهر، و رأى أنه من روائع هذا الإمام؛ إذ إن الأدباء و النقاد و البلاغيين، قد ظلوا دهرا طويلا يسمعون و يقرءون و يكتبون مصطلحات بيانية معروفة في أوساطهم، بيد أنهم لم يسمعوا قط بمعنى المعنى الكامن فيها. إلى أن طلع عليهم هذا الإمام، و غاص-بفكره النافذ-في أعماق النصوص التي تحوي معاني تلك المصطلحات، و إذا به يخرج إليهم بهذا الاستخراج الدقيق، و الاكتشاف الفريد. و من ثم رأى الباحث أن ذلك من أهم الإضافات التي أتحف بها الإمام عبد القاهر الأدباء و اللغويين، بصفة عامة، و البلاغيين و النقاد على وجه الخصوص. هذا بالإضافة إلى ذلك التقسيم الثنائي للمعنى، و غوصه في أعماق النصوص محللا و معللا بصورة انفرد بها عن سائر النقاد السابقين. انتقل الحديث بالباحث بعد ذلك إلى الفصل الثاني الذي كانت مهمته التجوال حول الصياغة و النظم. و قد انقسم-هو الآخر-إلى مبحثين اثنين، و تكفل المبحث الأول منهما بالحديث عن هذه القضية قبل وصولها إلى الإمام عبد القاهر؛ إذ تتبع الباحث-من خلاله-أهم آراء النقاد التي مست الصياغة و النظم بصورة أو بأخرى. و رأى الباحث=في المبحث الثاني من هذا الفصل-أن تلك الآراء لم تنصهر لتكوِّن فكرة النظم إلا عند ما انتهت إلى الإمام عبد القاهر؛ إذ نظر فيها نظرة عالم و مفكر، و وضعها في معيار العلم الصحيح، فاستخلص زبدتها، و كون منها فكرة النظم التي سارت بها الركبان، و تلقفها الباحثون من بعده يدرسونها، و يدندنون حولها معجبين بها وبصاحبها. و نقل الباحث-بالإضافة إلى آراء الإمام عبد القاهر-آراء بعض الباحثين الذين أشادوا بفكرة النظم هذه، و رأوا أنها جماع آراء الإمام عبد القاهر اللغوية و البلاغية، و أنها أهم ما يمكن أن نعتز به في تراثنا العربي. ثم تناول الباحث دور التقديم و التأخير في النظم و الصياغة عند الإمام عبد القاهر، و رأى أنه كان دورا عظيما، مما جعل الإمام يتخذه ركنا من أهم أركان النظم مع التعريف و التنكير، و الحذف و الإضمار و غير ذلك مما هو مذكور في موضعه هناك. و تناول الباحث-خلال الحديث عن النظم-تحليلات الإمام عبد القاهر الرائعة للنصوص وفق مقومات النظم عنده، و ذلك من الميزات التي امتاز بها عن غيره في هذا الشأن؛ إذ كان لا يكتفي في تقرير القواعد و الأسس بمجرد الذكر و السرد، بل كان دأبه تطبيق ذلك كله تطبيقا عمليا على النصوص مع الشرح و التحليل و التعليل، و تعيين موضع المزية و الفضل. و قد تبين للباحث أثناء حديثه عن النظم أن قد كان للإمام عبد القاهر-خلال تثبيته دعائم النظم وتحليله لمكوناته-فضل كبير و سعي مشكور في التوحيد بين اللغة و الشعر، أو المزج بين الدراسات النحوية الأدبية مزجا أدى إلى بناء لغوي واحد. و كذلك في النظرة إلى أنواع البلاغة كلها على أنها عبارة عن التنوع في إطار الوحدة. و أيضا في القضاء على ثنائية اللفظ و المعنى، تلك الثنائية التي طالما شغلت النقاد و الباحثين، و أخذت الكثير من وقتهم و جهدهم دون أن يصلوا إلى ما وصل الإمام عبد القاهر إليه من فكرة النظم. انتقل الباحث بعد ذلك إلى الفصل الثالث و الأخير، و تناول فيه قضية السرقات الشعرية، و قسمه-أيضا-إلى مبحثين، مر في المبحث الأول منهما على أهم آراء النقاد الذين سبقوا الإمام عبد القاهر. و رأى الباحث أن هذه القضية كانت من القضايا النقدية التي أثيرت بشكل لافت للنظر من قبل النقاد عند حديثهم عن القدماء و المحدثين؛ إذ وقف النقاد للشعراء بالمرصاد، فما أن ينشئ أحدهم قصيدة أو يقول بيتا من الشعر حتى يتصدى له النقاد يبينون أخذه و سرقته من سابقيه، أو سطوه و إغارته على آثار الآخرين. كل ذلك قد صوره هذا المبحث مع عرض لبعض آراء النقاد المهمة في إيجاز و اختصار. انتقل الحديث بالباحث بعد ذلك إلى المبحث الأخير؛ إذ تناول فيه رأي الإمام عبد القاهر في هذه القضية، فعرضه كما خططه له صاحبه، حين رأى أن اتفاق الشاعرين على معنى من المعاني ينقسم إلى أكثر من قسم. من ذلك المشترك العامي الذي لا يجوز لأحد أن يدعي فيه الأخذ و السرقة؛ فالناس فيه شركاء.
و قد سماه الإمام عبد القاهر اسما آخر بالإضافة إلى هذا الاسم، سماه-أيضا-المعنى العقلي. و من تلك الأقسام أيضا القسم التخييلي المخصوص بنوعيه كما فرعه الإمام : النوع الذي يمكن أن يدعى فيه الأخذ و السرقة، و النوع الذي لا يجوز أن يدعى فيه ذلك.
كل هذا و غيره كان هذا المبحث الأخير قد تكفل بتوضيحه و تبيينه. و رأى الباحث من خلال تناوله لهذه القضية أن الإمام عبد القاهر قد أضاف إليها أيضا إضافات، لها وزنها و ثقلها. من ذلك جعله المعنى المشترك نفسه يصير داخلا فيما يتملك بالفكرة، و يدعى فيه أخذ اللاحق من السابق، أ وسرقته منه، أو سطوه على بنات أفكاره، و نتائج قريحته. و ذلك إذا وصل بذلك المعنى المشترك لطيفة، أو دخل إليه من باب الكناية و التعريض، و ما جرى هذا المجرى مما هو مسطر و مدون في موضعه هناك. و من تلك الإضافات أيضا أن المعنى الخاص نفسه قد يكون حكمه حكم المعنى العام الذي لا يدعى فيه السرقة، إذا كان من المعاني المركوزة في الطباع، و المغروزة في النفوس. و من ذلك أيضا تفريقه بين السرقة و الاحتذاء، حيث لم يذكره-لا من قريب و لا من بعيد-من سبقه من النقاد الذين تكلموا في هذه القضية. و كان المعنى التخييلي قد جر الإمام عبد القاهر إلى الحديث عن الصدق و الكذب في الشعر. الأمر الذي جعل الباحث أيضا يضع قضية الصدق الكذب ضمن قضية السرقات الشعرية؛ لقلة المادة فيها من جهة، و لعلاقتها بالمعنى التخييلي المذكور في السرقات عند الإمام عبد القاهر من جهة أخرى. هذا، و قد تبين للباحث من خلال بحثه هذا أن منهج الإمام عبد القاهر اللغوي التحليلي منهج فريد و رائع. الأمر الذي جعل الباحثين يجمعون على امتيازه و تفرده، و صلاحيته ما دام للغة العربية عرق ينبض.
و قد نقل الباحث مجموعة من آراء بعض الباحثين، و لمحات من إشاداتهم لذلك المنهج الرائع الذي بهرهم قاطبة، و أدهشهم جميعا، فلم يسعهم إلا أن يطأطئوا رؤوسهم أمامه؛ إجلالا لصاحبه و تقديرا. و لله در القائل : و الناس أكيس من أن يحمدوا رجلا حتى يروا عنده آثار إحسان
التخصصات الرئيسية
الموضوعات
عدد الصفحات
162
قائمة المحتويات
فهرس المحتويات / الموضوعات.
الملخص / المستخلص.
المقدمة.
التمهيد.
الفصل الأول : قضية اللفظ و المعنى.
الفصل الثاني : الصياغة و النظم.
الفصل الثالث : قضية السرقات الشعرية.
الخاتمة.
قائمة المراجع.
نمط استشهاد جمعية علماء النفس الأمريكية (APA)
محمد عيسى أحمد. (2010). القضايا النقدية في كتابي دلائل الإعجاز و أسرار البلاغة لعبد القاهر الجرجاني. (أطروحة ماجستير). جامعة أم درمان الإسلامية, السودان
https://search.emarefa.net/detail/BIM-360158
نمط استشهاد الجمعية الأمريكية للغات الحديثة (MLA)
محمد عيسى أحمد. القضايا النقدية في كتابي دلائل الإعجاز و أسرار البلاغة لعبد القاهر الجرجاني. (أطروحة ماجستير). جامعة أم درمان الإسلامية. (2010).
https://search.emarefa.net/detail/BIM-360158
نمط استشهاد الجمعية الطبية الأمريكية (AMA)
محمد عيسى أحمد. (2010). القضايا النقدية في كتابي دلائل الإعجاز و أسرار البلاغة لعبد القاهر الجرجاني. (أطروحة ماجستير). جامعة أم درمان الإسلامية, السودان
https://search.emarefa.net/detail/BIM-360158
لغة النص
العربية
نوع البيانات
رسائل جامعية
رقم السجل
BIM-360158

قاعدة معامل التأثير والاستشهادات المرجعية العربي "ارسيف Arcif"
أضخم قاعدة بيانات عربية للاستشهادات المرجعية للمجلات العلمية المحكمة الصادرة في العالم العربي

تقوم هذه الخدمة بالتحقق من التشابه أو الانتحال في الأبحاث والمقالات العلمية والأطروحات الجامعية والكتب والأبحاث باللغة العربية، وتحديد درجة التشابه أو أصالة الأعمال البحثية وحماية ملكيتها الفكرية. تعرف اكثر