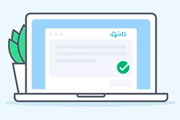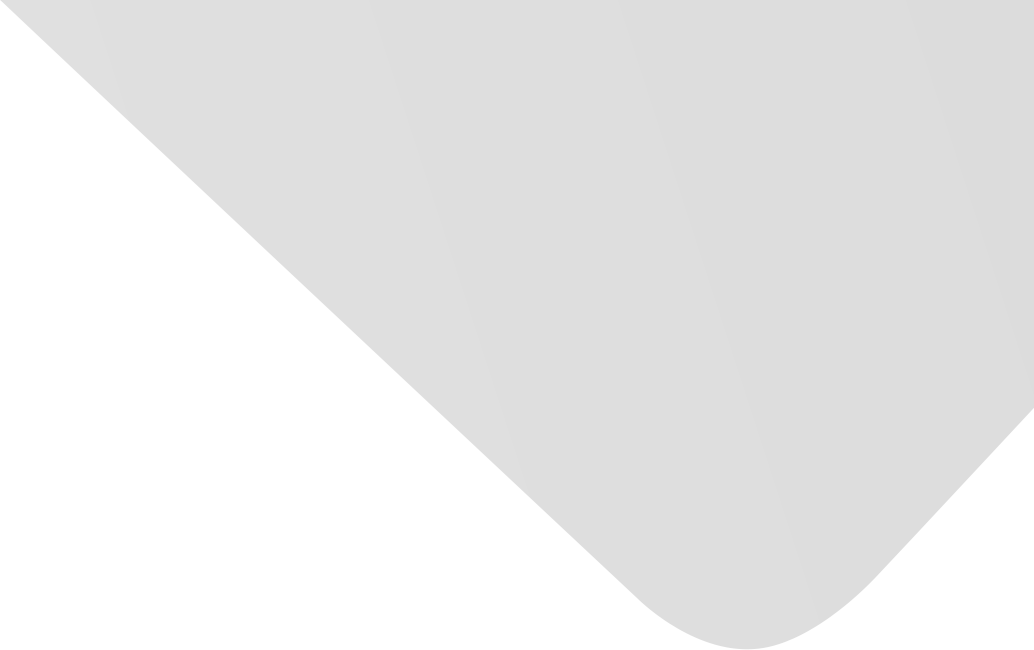
الإشكالات الإجرائية للشهادة في المسائل الجزائية : دراسة مقارنة
العناوين الأخرى
The procedural predicaments of testimony in criminal proceeding : a comparative study
مقدم أطروحة جامعية
مشرف أطروحة جامعية
أعضاء اللجنة
الطوالبة، علي حسن
الشاوي، سلطان عبد القادر
عبد الرحمن توفيق أحمد
الجامعة
جامعة عمان العربية
الكلية
كلية القانون
دولة الجامعة
الأردن
الدرجة العلمية
دكتوراه
تاريخ الدرجة العلمية
2005
الملخص العربي
تعتبر الشهادة في القضايا الجزائية من أهم الأدلة في الإثبات، و هي لا تقل أهمية عن الدليل الكتابي في القضايا المدنية، بل و تعتبر الدليل الوحيد في اكثر الأحيان لأن الجرائم هي وقائع مادية، و الوقائع المادية يتعذر إثباتها بغير الشهادة في أغلب الحالات.
هذا ولما كان للشهادة في المسائل الجزائية هذه الأهمية، فقد كانت محط اهتمام الباحث لإلقاء الضوء على أهم الإشكالات التي تعتريها كدليل إثبات أو دليل نفي، لذلك كان موضوع البحث يدور حول الاشكالات الإجرائية الخاصة بها و التي تواجه القضاء أو القائمين على حقوق المجتمع و العباد منذ تاريخ وقوع الجريمة و حتى صدور القرار في الدعوى.
لهذا تم تقسيم هذه الأطروحة إلى فصل تمهيدي و ثلاثة أبواب : تناول الباحث في طيات الفصل التمهيدي، ماهية الشهادة بشكل عام، فتطرق إلى تعريفها، و بيان أنواعها، و مصدرها.
فخلص في تمهيده إلى أن الشهادة هي تقرير الشخص لما يكون قد رآه أو سمعه بنفسه أو أدركه على وجه العموم بحواسه، بطريق إخبار شفوي يدلي به في مجلس القضاء بعد يمين يؤديها على الوجه الصحيح.
و أن مصدر الشهادة هو الشاهد, و هو كل شخص لديه معلومات تفيد في كشف الحقيقة، شريطة أن يكون عاين الواقعة بأحد حواسه، و أن يكون مدركا عاقلا لما يدور حوله، و أن هذه الشهادة تعد في نظر الشرع و القانون و الفقه و القضاء هي الشهادة المباشرة، و التي تختلف بدورها عن الشهادة غير المباشرة، و الشهادة الاستدلالية، و هي أقواها في التدليل.
هذا و بعد الانتهاء من التمهيد السابق تناول الباحث الباب الأول، و ضمنه الاشكالات الإجرائية للشهادة في المسائل الجزائية في مرحلة التحقيق الأولي (مرحلة الاستدلال).
و قسم هذا الباب إلى ثلاثة فصول، تناول في الأول منها الطبيعة القانونية لمرحلة التحقق الأولي "الاستدلال".
هذا و قد تم تقسيم الفصل الأول من الباب الأول إلى مبحثين، تناول الباحث في الأول منها التعريف بمرحلة التحقيق الأولي "الاستدلال"، فعرفها بأنها مجموعة من الإجراءات التمهيدية السابقة على تحريك الدعوى الجنائية، تهدف إلى جمع المعلومات بشأن جريمة ارتكبت كي تتخذ سلطات التحقيق بناء عليها القرار، فيما إذا كان من الجائز أو من الملائم تحريك الدعوى الجنائية من عدمه.
و بعد تعريفها تمت التفرقة بينها و بين التحقيق الابتدائي، و من ثم بين الباحث أثر أعمال التحقيق الأولي على تحريك الدعوى الجنائية و وضح الآراء الفقهية في ذلك، و من ثم تطرق إلى موقف التشريعات من طبيعة هذه المرحلة و بيان أهميتها و السلطات المختصة بها.
أما الفصل الثاني من هذا الباب، فتناول سلطات الضابطة العدلية بسماع الشهود طبقا لاختصاصاتها الأصلية، و قد تم التطرق إلى عدة موضوعات، منها مشروعية سماع الشهود من قبل الضابطة العدلية أثناء ممارستها صلاحياتها الأصلية، و بيان الوسائل المتبعة التي تتبعها سلطات الضابطة العدلية في تعبئة الشهود و معرفتهم، و من ثم التمييز بين الشاهد و المشتبه به، و أخيرا بيان الإجراءات المتبعة بسماع الشهود من قبل رجال الضابطة العدلية في الظروف العادية طبقاً للصلاحيات الأصلية لها.
أما الفصل الثالث من هذا الباب، فقد تناول سلطات الضابطة العدلية بسماع الشهود طبقا للظروف الاستثنائية، و قد تم تقسيمه إلى مبحثين، تناول الأول منها سلطات الضابطة العدلية بسماع الشهود في حال الجرم المشهود (التلبس)، فقد تم تبيان ماهية الجرم المشهود، و الضوابط التي تحكم سماع الشهود عند توافر حالة من حالاته.
أما المبحث الثاني، فقد تناول سلطات الضابطة العدلية بسماع الشهود في حال ندبهم لذلك من قبل سلطة التحقيق الابتدائي.
فبين الباحث ضوابط الندب بشكل عام، و من ثم تطرق إلى توضيح صلاحيات عضو الضابطة العدلية عند انتدابه لسماع الشهود.
أما الباب الثاني من هذا البحث، فقد ضمنه الباحث الاشكالات الإجرائية للشهادة في مرحلة التحقيق الابتدائي، و دون في مضمونه بيان السلطات المختصة بالتحقيق الابتدائي في التشريعات المختلفة، و بيان فئات الشهود الواجب دعوتهم، و توضيح إجراءات تكليفهم بالحضور، و كيفية سماع الشهود من قبل سلطات التحقيق في هذه المرحلة، و بيان السلطة الممنوحة لسلطات التحقيق الابتدائي في حقها بتقدير الشهادة.
فعند بيان السلطة المختصة بالتحقيق الابتدائي، تبين للباحث أن التشريعات اختلفت فيما بينها في إناطة سلطة التحقيق الابتدائي بجهة معينة، فمنها من يعطي هذه السلطة لجهة واحدة هي النيابة العامة، كما هو الحال في التشريع الأردني، و منها من أعطاها إلى قاضي التحقيق كالتشريع السوري، و منها من أعطى هذه السلطة إلى النيابة العامة و قاضي التحقيق كما هو الحال في التشريع الفرنسي و التشريع المصري.
أما فئات الشهود الواجب دعوتهم و سماعهم، فإن سلطة التحقيق لها كامل الحرية في سماع من ترى سماعهم من الشهود سواء أطلب الخصوم ذلك أم لم يطلبوا، و لها أن ترفض سماع من يطلب إليها سماعهم إذا رأت عدم الفائدة من سماعهم في ثبوت الجريمة و ظروفها و إسنادها إلى المشتكى عليه أو براءته منها.
و تتم دعوة الشهود عن طريق تبليغهم مذكرة الحضور، سواء أكان داخل البلد أم خارجها، و إذا لم يمتثل يتم إحضاره بالقوة الجبرية إذا كان مقيما داخل البلد، أما إذا كان خارجها، فإنه لا يجبر على الحضور.
و إذا لم يحضر الشاهد بسبب مرضه، أو كان رئيسا للدولة، أو من كبار موظفيها، يتم الانتقال إلى مكان إقامته أو عمله للاستماع إليه.
و إذا لم يستطع الشاهد الحضور، و لم تستطع سلطة التحقيق الانتقال لسماع شهادته، تقوم سلطة التحقيق بإنابة سلطة موازية لها في سماع شهادته سواء أكان داخل البلد أم خارجه، و من ثم تطبيق الاتفاقيات الدولية إذا كان هنالك اتفاقية بين الدولة المنيبة و الدولة المنابة.
فإذا حضر الشاهد، أو تم الانتقال إليه لسماع شهادته، أو تمت الإنابة بسماع شهادته، فإنه يتم الاستماع إليه بعد حلف اليمين القانونية إذا كان يدرك كنهها و التحقق من هويته، و يدلي بشهادته بصورة إسهابية، أو بناء على أسئلة توجه إليه فيجيب عنها، على أن يتم الاستماع إليه بعيدا عن حضور الخصوم بصورة سرية.
و إذا كان الشاهد أجنبيا عين له المحقق مترجما ليترجم بينه و بين الشاهد، و إذا كان أصم أبكم يعرف الكتابة دونت له الأسئلة فيجيب عليها، و إذا كان لا يعرف الكتابة عين المحقق له خبيرا يفقه الإشارة ليترجم الإشارة بينه و بين الشاهد، و يتم تحرير محضر أقوال الشاهد من قبل كاتب الضبط أو باستخدام الكمبيوتر.
و على المحقق أن يميز بين الشاهد و المشتبه به في هذه المرحلة و له الحق في تقدير الشهادة أو البينة المؤداة في هذه المرحلة حتى يستطيع اتخاذ أي من القرارات المسموح له باتخاذها، من إحالة الدعوى، أو تكييف الدعوى، أو منع المحاكمة، أو إسقاطها.
أما الباب الثالث فقد تناول في طياته الباحث الاشكالات الإجرائية للشهادة في المسائل الجزائية في مرحلة المحاكمة.
و قد تم تقسيم هذا الباب إلى ثلاثة فصول : تناول الأول منها ضوابط الشهادة المباشرة في مرحلة المحاكمة، و الثاني تناول الشهادة على السماع (الشهادة غير المباشرة) و موقف التشريعات منها، أما الفصل الثالث فقد تم تخصيصه لبيان المشاكل الإجرائية المتعلقة بتقدير و وزن قيمة الشهادة في الإثبات الجزائي.
و قد تم تقسيم الفصل الأول من هذا الباب إلى ثلاثة مباحث، تناول المبحث الأول منها القواعد الإجرائية التي تحكم الشهادة في مرحلة المحاكمة، و تناول الثاني إجراءات سماع الشهود في هذه المرحلة، و بيان المبررات التي من خلالها يمكن للشاهد الامتناع عن الشهادة في المبحث الثالث.
هذا و تطرق المبحث الأول من الفصل الأول، من هذا الباب، إلى توضيح قاعدة علنية الشهادة و الضوابط التي تحكمها و الاستثناءات الواردة عليها، و بعد ذلك تناول الباحث قاعدة الشفوية و بيان ضوابطها و الاستثناءات الواردة عليها.
أما المبحث الثاني من الفصل الأول من هذا الباب، فقد تناول إجراءات سماع الشهود من خلال بيان دور الخصوم في دعوة الشهود أمام المحكمة و مناقشتهم و الاعتراض على سماعهم، و بيان دور المحكمة في ضبط و ترتيب الاستماع إلى الشهود، و دور المحكمة في تلاوة أقوال الشاهد المأخوذة في مرحلة التحقيق الابتدائي، و بيان الضوابط التي تعطي المحكمة صلاحية التلاوة.
أما المبحث الثالث من الفصل الأول من هذا الباب، فقد تناول مبررات الامتناع عن الشهادة.
و من خلال البحث تبين أن الشاهد يستطيع الامتناع عن الشهادة بتذرعه بسر المهنة إذا كان ملزما بعدم البوح به، أو امتنع عن الشهادة بسبب تعارض صفته كشاهد، أو كان قريبا للجاني أو المشتكى عليه لدرجة معينة، كأن يكون أصلا أو فرعا له، أو يمتنع عن الشهادة بسبب الخوف من المجرمين و أصحاب النفوذ، و قد اجتهدت بعض التشريعات بوضع حلول للحالة الأخيرة بأن و ضعت برامج لحماية الشهود حتى تشجعهم على الإقدام للإدلاء بالشهادة.
و تناول الفصل الثاني من هذا الباب "الشهادة على السماع و موقف التشريعات الوضعية منها (الشهادة غير المباشرة)".
و من خلال الدراسة و البحث تبين للباحث أن التشريعات التي أخذت بهذا النوع من الشهادة هي محصورة و تكاد لا تذكر، و نذكر منها على سبيل المثال المشرع الأردني و الإيطالي و القطري.
و يعتبر الأخذ بالشهادة على السماع (الشهادة غير المباشرة) بحد ذاته إشكالية من الإشكاليات التي تواجه القضاء عند وزنه للبينة.
و للأهمية تم تناول هذا الفصل ضمن مبحثين، تناول الأول شرط الشهادة على السماع المنقولة عن شاهد في الدعوى، و الثاني تناول الاستثناءات الواردة على الشهادة المنقولة عن الشاهد في الدعوى.
فتبين أن الشهادة على السماع حتى يمكن الأخذ بها كدليل يجب أن تكون منقولة عن قول قاله الشاهد في وقت مقارب لوقوع الجرم، و إن يكون الشخص المنقول عنه هو شاهد في الدعوى، و إن تكون الشهادة المنقولة منصبة على وقائع الدعوى و معتدا بها كدليل.
أما الفصل الثالث من هذا الباب، فقد تم تخصيصه لبيان المشاكل الإجرائية المتعلقة بتقدير و وزن قيمة الشهادة في الإثبات الجزائي.
و قد تم التطرق في طيات هذا الفصل إلى توضيح أهم المبادئ القانونية التي تحكم القاضي الجزائي في تقدير قيمة الشهادة في الإثبات، و مدى تأثير المبادئ على سلطة المحكمة في تقدير الشهادة.
و من خلال البحث تبين أن أهم المبادئ التي تحكم القاضي الجزائي في وزنه للشهادة، بالإضافة إلى العلنية و الشفوية، مبدأ حريته في تكوين قناعته من الدليل شريطة أن تبنى القناعة على الجزم و اليقين، و ليس الشك و التخمين، و إن تكون الأدلة المعول عليها صحيحة، لها اصل في أوراق الدعوى، شريطة أن لا يكون المشرع قيد القاضي بطرق إثبات خاصة في بعض الجرائم.
و بتطبيق هذه المبادئ يظهر للباحث أن سلطة المحكمة في وزن الشهادة تكون تارة تقديرية و تارة أخرى مقيدة.
فهي تقديرية للأخذ بالشهادة أو رفضها، و لها أن تجزئها ولها أن تأخذ بشهادة الشاهد في أية مرحلة من مراحل الدعوى، و لها أن تؤسس قناعتها على شهادة فردية، و لها أن تأخذ بشهادة الشاهد ولو كان قريبا للمجني عليه، أو كان هو المجني عليه أو صاحب مصلحة في الدعوى.
و تكون سلطتها مقيدة إذا قيدها القانون، أو القضاء ، فلا يحق للمحكمة أن تبني حكمها على شهادة نقلت عن شهادة تم الإدلاء بها على سبيل الاستدلال ما لم تكن مؤيدة ببينة أخرى غير منقولة عنها.
و لا يحق لها كذلك أن تبني حكمها على شهادة سماعية دون أن تستمع إلى الشاهد المنقول عنه كشاهد في الدعوى إلا إذا تعذر حضوره بسبب وفاته، أو مرضه، أو سفره خارج البلد، و لا يحق للمحكمة أن تعتمد على أقوال الشهود في الحكم ببعض الجرائم المنصوص عليها قانونا و التي تحتاج إلى أدلة إثبات معينة للحكم بها كجريمة الزنى، و خيانة الأمانة، و لا يحق للمحكمة تلاوة أقوال شاهد تعذر حضوره، إلا إذا كان هذا الشاهد قد أدلى بشهادة في مرحلة التحقيق الابتدائي تحت القسم القانوني، و لا يحق لها الاستماع إلى أجنبي إلا بمترجم، و لا إلى أصم أبكم إلا بوجود خبير إشارة يفهم إشارة الصم و البكم، و كذلك لا يحق لها الأخذ بشهادة شاهد متناقضة مع دليل فني، و لا أن تبني حكمها على أقوال شاهد هي لم تستمع إليه بنفسها.
و خلص الباحث في نهاية بحثه إلى خاتمة تحوي النتائج و التوصيات التي وصل إليها من خلال بحثه.
التخصصات الرئيسية
الموضوعات
عدد الصفحات
328
قائمة المحتويات
فهرس المحتويات / الموضوعات.
الملخص / المستخلص.
المستخلص باللغة الإنجليزية.
المقدمة.
الفصل التمهيدي : ماهية الشهادة في المسائل الجزائية.
الباب الأول : الاشكاليات الإجرائية للشهادة في مرحلة التحقيق الأولي-الاستدلال.
الباب الثاني : الإشكالات الإجرائية للشهادة في المسائل الجزائية في مرحلة التحقيق الإبتدائي.
الباب الثالث : الإشكالات الإجرائية للشهادة في المسائل الجزائية في مرحلة المحاكمة.
الخاتمة، النتائج، التوصيات.
قائمة المراجع.
نمط استشهاد جمعية علماء النفس الأمريكية (APA)
العبد اللطيف، إحمود فالح حمود. (2005). الإشكالات الإجرائية للشهادة في المسائل الجزائية : دراسة مقارنة. (أطروحة دكتوراه). جامعة عمان العربية, الأردن
https://search.emarefa.net/detail/BIM-442430
نمط استشهاد الجمعية الأمريكية للغات الحديثة (MLA)
العبد اللطيف، إحمود فالح حمود. الإشكالات الإجرائية للشهادة في المسائل الجزائية : دراسة مقارنة. (أطروحة دكتوراه). جامعة عمان العربية. (2005).
https://search.emarefa.net/detail/BIM-442430
نمط استشهاد الجمعية الطبية الأمريكية (AMA)
العبد اللطيف، إحمود فالح حمود. (2005). الإشكالات الإجرائية للشهادة في المسائل الجزائية : دراسة مقارنة. (أطروحة دكتوراه). جامعة عمان العربية, الأردن
https://search.emarefa.net/detail/BIM-442430
لغة النص
العربية
نوع البيانات
رسائل جامعية
رقم السجل
BIM-442430

قاعدة معامل التأثير والاستشهادات المرجعية العربي "ارسيف Arcif"
أضخم قاعدة بيانات عربية للاستشهادات المرجعية للمجلات العلمية المحكمة الصادرة في العالم العربي

تقوم هذه الخدمة بالتحقق من التشابه أو الانتحال في الأبحاث والمقالات العلمية والأطروحات الجامعية والكتب والأبحاث باللغة العربية، وتحديد درجة التشابه أو أصالة الأعمال البحثية وحماية ملكيتها الفكرية. تعرف اكثر