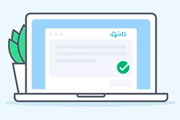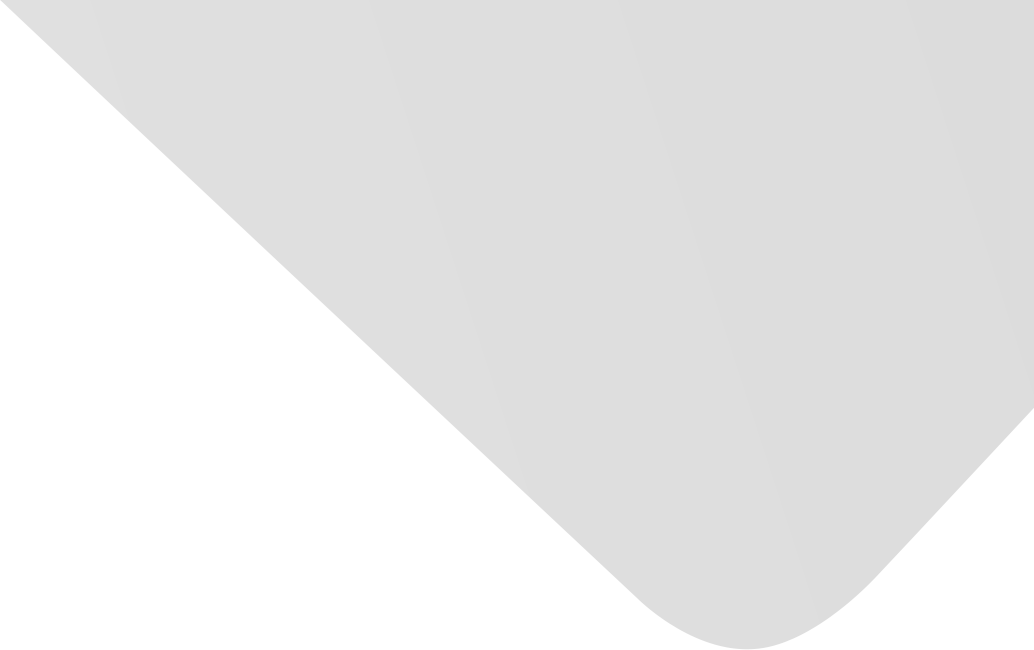
المعذب في الشعر العراقي الحديث 1958-2000
Other Title(s)
The anguished person in the modern Iraqi poetry 1958-2000
Dissertant
Thesis advisor
University
University of Baghdad
Faculty
College of Education for Human Sciences-Ibn Rushd
Department
Department of Arabic Since
University Country
Iraq
Degree
Ph.D.
Degree Date
2005
Arabic Abstract
ولد العذاب بولادة أول إنسان على الأرض.
و كان و ما يزال قدر الكثيرين : أمما و شعوبا و أفرادا.
و كان نصيب الشعراء منه –و سيظل- النصيب إلا و في بحكم حساسيتهم المفرطة بإزاء الموجودات، و تأجج مشاعرهم، و جيشان عواطفهم التي جبلوا عليها.
و لعل الشعراء الرومانسيين أول من التفت إلى الألم، و أنسوا به، و تعلقوا بأسبابه، و عدوه هاجسهم الاول في الحياة، فالذات التي حرروها من ربقة الاستعباد الجمعي، صارت ترتاد الآفاق البعيدة و تتشرنق في صومعات الاغتراب، و تنفر من المدن، و تنعطف نحو البرية بأكواخها و فلواتها، و نحو الغابات بأشجارها و حيواناتها.
و لا شك في أن الرومانسية تشكل ثورة على الموروث القديم بسبب دواع سياسية و اجتماعية و أخرى ذاتية -نفسية صاغت في أتونها وجدان الشاعر الرومانسي و طبعته بطابع الحزن و اليأس و الاحباط.
أما تجليات المعذب عند الشعراء الرومانسيين فقد أظهرت الدراسة أنموذجين : الأول ...
هو المعذب المغترب العدمي ...
و قد افرز نمطين هما : الوجودي المغترب روحيا، و المغترب اجتماعيا.
و من البداهة القول أن وراء نشوء هذين الانموذجين هو انهيار قيمة الأهداف و المثل العليا عند الشاعر الذي وجد نفسه محاصرا في محيط اجتماعي زاخر بالمنغصات و الاحباطات.
و من هنا كان الشك الذي تلبسه : الشك في الحياة لأن وراءها الموت، و الشك بكل ما حوله و من حوله.
و هكذا تصير حياة الشاعر جحيما، يكتوي بناره، و يعاني فيه من شتى أنواع الآلام و المكابدات الحادة.
أما الأنموذج الثاني من المعذب الذي افرزته المدرسة الرومانسية فهو السوداوي و قد ارتأينا توصيفه ضمن اربعة أنماط : فهناك المحروم عاطفيا، و هناك الكئيب، و هناك القلق و اليائس، و أخيرا هناك المتحد بالعذاب، و اللائذ به حد التوحيد.
و حين نلج عالم العذاب عند الشاعر الحداثي فسوف نقف على بعض الظواهر الفنية و الحقائق الموضوعية التي اندغمت ببعضها اندغاما جدليا عصيا على الانفراط.
و الباحث إذ يثبت تلك الظواهر و الحقائق فإنه يرى– بتواضع– أنها قد تحمل ملامح النتائج التي كان يسعى إلى استخلاصها و هي ثمرة البحث و التدقيق الصادقين –أن شاء الله – اللذين استغرقا وقتا منه ليس بالقصير : • إذا كان الألم عند الرومانسيين قد أفضى بهم إلى الانكفاء على الذات و الشك بكل شيء بسبب أوضاع المجتمع العربي و تراكم الاحباطات السياسية و الاجتماعية من استعمار و تجزئة و أنظمة طبقية و ما يتصل بذلك من قيم سلبية كالاستغلال و الكبت، فان الألم عند شعراء الحداثة كان الما خلاقا، فمع استمرار النكسات على المستويين القومي و الوطني، إلى جانب تقدم الآلة، و ما افرزته من علاقات نفعية، و مصالح مادية شرهة، و نمو المدن الصناعية و سيادة منطق القوة و القهر، و تضخم المؤسسات و القيم المؤسساتية اقول مع كل ذلك وجد الشاعر الحداثي نفسه أمام تحديات كبرى على المستويين الذاتي و الموضوعي، كان لا بد، من زاوية وعيه اليقظ من مواجهتها و النضال ضدها في طريق شاقة و طويلة، ليس بالشعر التقليدي في محاكاته، و فوتوغرافيته و خطابيته، و ليس بالشعر الرومانسي في يأسه و احباطه و اغترابه السلبي ، و لكن بخطاب شعري جديد صادر عن رؤيا كونية، و حدس فني، يسندهما فكر غير مرئي، و مرجعيات معرفية شتى.
أنه البحث عن عالم آخر يبتنى –آجلا أم عاجلا– على أنقاض هذا العالم الخراب المليء بالتعقيد و العنف و اللاموضوعية.
و لا نستطيع أن نبين خطا بيانيا بعذاب الشاعر في العقود التي حددها البحث ذلك أن النصوص تشير إلى أمر رئيس واحد هو أن المذاهب الأدبية هي التي تحدد نوع العذاب الذي عانى منه الشاعر فكما جاء في البحث من أن عذاب الشاعر الرومانسي هو عذاب ذاتي في معظمه على الرغم من ان أسباب نشوئه موضوعية أي أن أوضاع المجتمع بعد الحربين الكونيتين و ما بينهما هي التي فرزت ذلك العذاب و طبعته بطابع اجتماعي شامل و لكن الشاعر الرومانسي أحال ذلك العذاب الاجتماعي إلى عذاب فردي استحال فيما بعد إلى قيمة فنية طبع عليها الشاعر و استبدت به الى الحد الذي كان يدفعه إلى البحث عن منابع الألم و الجري وراء الجراح بما يشفي غليله و يروي ظمأه.
و في المذهب الحداثي كشفت النصوص من أن الشاعر كان يتعذب من أجل المجتمع الذي هو جزء منه بل هو صوته الداوي.
و من هنا ...
كان الم الشاعر الحداثي ألما خلاقا، و أملا يضيء جوانح الشاعر و يلهمه أسباب الصمود و القوة و اليقين.
و باختصار ...
فان عذاب الشاعر الحداثي عنصر من عناصر كفاح المجتمع و تحديث بنياته الاجتماعية و السياسية و الاقتصادية و الثقافية في عصر الانترنيت و الهواتف النقالة حيث بات العالم قرية صغيرة.
• أن توافر الشاعر الحداثي على ذخيرة معرفية ثرية عمقت وعيه و رفعت من درجة حساسيته بإزاء المحيط و ما يزخر به من تناقضات و تحديات.
و لذلك فأن اغترابه ليس انعزالا عن المجتمع او انكفاءا على الذات –كما أوضحت النصوص الشعرية -بل كان حافزا له على مواجهة الاغتراب، و التجذيف ضد التيار و البحث عن قوى معنوية و روحية جديدة يستعيد بها توازنه، و يستزيد من معينها ما يشد ازره في درب كفاحه الطويل، و هكذا احال الشاعر الحداثي الاغتراب من عتلة جذب نحو الخلف إلى قوة دفع الى الامام.
• و كما كان الأمر في الاغتراب فأن تصوف الشاعر الحديث لم يكن تصوفا دينيا، يلزمه القعود في أماكن العبادة، أو الانزواء في التكايا، و استغراق الليل في التهجد، بل كان استدعاء للرموز الصوفية من شخصيات و مدن و مواقع تاريخية استهدفها الطغيان فيما مضى، و أصبحت الآن عناصر الهام للشاعر الحداثي ، فالشهداء و الثوار القدامى من ضحايا الاضطهاد و القهر يتجلون في ثوار و شهداء جدد، والمدن التي استباحها الغزاة في العصور الغابرة تنهض من بين ركام الحرائق، و قد البسها الشاعر حلة حديثة تليق بتضحياتها.
• و لم تكن المدينة عنصر يأس و إحباط لدى الشاعر الحداثي و هو و أن اتهمها بالاستسلام لعوامل القهر، و عناصر التفسخ فانه يحلم في بعثها معافاة و قد استعادت براءتها، و طهارة علاقاتها، و نقاء ناسها بل أن بعض شعراء الحداثة -كما رأينا في بعض النصوص– يروضون مدن الغربة و يؤالفون بينها و بين ذواتهم في محاولة لتخطي الم الاغتراب و معاناة الغربة.
• كذلك كانت الطفولة عنصر حياة جديدة للشاعر الحداثي، فاستدعاؤها لا يعني الهرب من الواقع بل يعني الاستزادة من براءة مرحلتها، و عفوية علاقاتها، و جمال ايامها ليسبغها على حاضره المثقل بالمكابدة و الألم.
• أما الموت فعلى الرغم من سطوته و جبروته إلا أن الشاعر الحداثي لم يقف امامه عاجزا، أو نائما، أو مستسلما بل راح يلتقط انفاس الحياة المبعثرة هنا و هناك، ثم راح يلمها في اضمامة حية من المشاعر، متوهجة بالتحدي و المغامرة، و ملتسبة بالأمل الخفي، و كما و شت بعض النصوص، فقد كان الموت عند الشاعر الحداثي الوجه الاخر للحياة، و كان أيضا عند بعضهم موتا من أجل الانبعاث، الم يكن الموت رمزا للتضحية و الفداء و الخلاص.
• و لم تكن المرأة عند الشاعر الحداثي رمزا للمتعة، أو ملهاة يتسلى بها الرجل، بل كانت رمزا بكل ما هو جليل و مقدس، فهي رمز للأم او الاخت حينا، و للأرض و الثورة حينا آخر، و هي حينا ثالثا بحث عن "الذات" المفقودة أو المستترة و هي قبل هذا و ذاك رمز للخصوبة و الولادة المتجددة و من هنا فأن الشاعر لم يتكئ على جسدها، أو يسبح في احلامه الوردية حيالها، و إنما اتخذ منها ذاتا أخرى تتصل بأكثر من و شيجة بذاته المبدعة فمنحها أفضل ما يستطيع من الإجلال، و الاكبار، و كان طيفها الاثيري ماثلا امام عينيه، و مقيما في وجدانه.
• و إذا توقفنا عند المرأة ...
الكيان و الانثى فأننا نقف بإزاء عذاب مزدوج عانت منه و ما تزال، تارة بسبب الشرف، و أخرى بسبب الدين، و ثالثة بسبب الحب، و أحيانا بسبب ذلك كله، و لعل الباحث أول من يتناول هذا الموضوع الذي يتحمل المزيد من الدراسة و البحث و لكنها الاطلالة الأولى و قد كشفت عمق ما تعانيه المرأة العراقية بعامة، و الشاعرة بخاصة، فهي إنسان تخضع لما يخضع له ابناء المجتمع من ظلم ، و قهر، و هي أنثى تحتل في سلم العلاقات المرتبة الثانية بعد الرجل، و أخيرا هي شاعرة تشعر بما لا تشعر به الاخريات أو هي في الأقل تشعر بما تشعر به الاخريات و لكن مع الأحساس بالتفاصيل التي قد لا تحس بها المرأة الاعتيادية.
فإذا انتهينا من هذه الحقائق الموضوعية فسنلج عالم الظواهر الفنية، و لاشك عند الباحث في ان الشاعر الحداثي – كما اسلفنا – يمتح من خزين معرفي ثر، و ثقافته مزيج من الأدب، و الفكر، و الفلسفة، و الاجتماع، فلم يعد الشعر -عنده – قولا مرتجلا، أو نصا عفويا تنتجه السليقة، بل هو نص مركب من عناصر معرفية شتى، تتفاوت في تغلغلها في انساقه من نص إلى آخر و على وفق ما يقصده الشاعر.
أي أن الشعر عنده لا يخلو من كد ذهني، و لذلك فان الناقد أو المتلقي الواعي –هو من يستطيع أن يقف عند تخوم النص، يستنطقه و يكتنه أغواره، و يفض اسراره.
و من هنا فأن ظواهر فنية برزت من هذا النص و من حوله لعل أبرزها كما افرزته النصوص المختارة في متن هذا البحث : • اتسم النص الحداثي بالغموض ليس لأن الشاعر قصد اليه و لكن تجربة الشاعر الراهنة، المصقولة بالفكر الثري، و المدعومة بالرؤيا الشمولية هي التي استدعت ذلك الغموض فللشاعر الحداثي نظرة جديدة الى الحياة و ظلالاتها.
زيادة على أن (الصنعة) لها دور مؤثر في إنتاج النص.
و الغموض – ظاهرة فنية- يجعل الم الشاعر الحداثي بين بين، فلا هو بالظاهر، و لا هو بالمستتر.
• كما توافر النص الحداثي للشاعر المعذب على رؤيا شاملة و معقدة تؤكد على اولوية المعرفة الحدسية أساسا لفهم طبيعة هذا النص، وهي رؤيا تتصل بطبيعة التجربة الفنية ذات الابعاد المعرفية و النفسية و الايديولوجية، فالشاعر المعذب ليس شاعرا سطحيا، أو ساذجا يعتمد السليقة في الإنتاج، و يستند إلى البديهة، و إنما هو شاعر مثقف، يصرف عذاباته عبر خزينه الثقافي.
و لذلك فقد زامن بين الماضي و الحاضر و المستقبل، و مزج بين الضمائر (انا –انت–هو ).
• يستخدم شاعر الحداثة المعذب ما يسمى بـ (التداعي الحر)، إذ تتتابع الصور النفسية و الأفكار، دون وجود رابط منطقي في الظاهر، و لكنها في الباطن تستند إلى معطيات سرية يعيها الشاعر.
و لذلك يلجأ إلى إسقاط أدوات الربط و غيرها من وسائل الأعراب التي تساعد القارئ الاعتيادي على فهم النص و استيعابه، و إسقاط ادوات الربط هو نتيجة لتدفق تجربة الشاعر، الذي يجد نفسه في سباق مع تجربة عنيفة – فنيا طبعا – لا تسمح له بالتقاط النفس، و بالتالي تحول بينه و بين استخدام أدوات الربط.
• النص الحداثي نص مركب أي انه نص مفتوح على دلالات كثيرة، فهو نص يتجدد بتعدد القراء أو المتلقين و من هنا فأن لكل قارئ فهمه للنص، و قد يفهم ناقد ما نصا معينا، لا يقره ناقد آخر على فهمه، و من هنا فأن ما قدمه الباحث من قراءة للنصوص المختارة، قد لا يتطابق مع قراءة باحث آخر.
• و قد جلت بعض النصوص أن (التكثيف) أحد سمات النص الحداثي للشاعر المعذب ففيه من التعدد الدلالي، و الثراء الفني ما يتسع لقراءات متعددة، و ذلك بسبب خصوصيته التقنية التي تسمح للأفكار و الرؤى و ظلال الدلالات أن تمتد الى اللانهاية.
• أن للنص الحداثي للشاعر المعذب خصوصية الاتساع لأكثر من ثيمة واحدة.
فقد يتسع النص الواحد لأكثر من تجل : فما يفهمه باحث ما من أن الاغتراب هو تجلي نص شاعر ما، فأن باحثا آخر يرى فيه تجليا للتصوف، أو مجلــن لاستدعاء الطفولة، أو موقفا بإزاء الموت...
و هكذا.
و من هنا قلنا أن النص الحداثي هو نص مركب، و مفتوح على الايحاءات المتعددة.
لقد كشف البحث عن أن شعراء الحداثة انتهجوا سبلا جديدة في استخدام اللغة، و صياغة الصورة، و مع انهم لم يبتدعوا ايقاعا خاصا بهم –عدا جنوح البعض منهم نحو قصيدة النثر –إلا أن اللغة و الصورة منحا الايقاع نكهة جديدة.
• فقد رأينا كيف طوع شعراء الفلسفة، و الفكر في تأسيس البنية اللغوية فأنتجوا النص الفلسفي زيادة على نص اللغة اليومية المتداولة.
و قد عضدت الصورة البنية اللغوية من خلال الرمز الاسطوري و الرمز السياقي اللذين منحا اللغة بكارتها الأولــى.
• و كان للقص الشعري فضاؤه الخصب في تجسيم الفكر بعيدا عن التقعر.
فلم تعد الصورة حلية يزين بها الشعراء القصيدة بل اصبحت ملمحا لشحنات ذهنية تتوافر على الحركة و الصوت و اللون و كأنها جاءت لتعوض عن سحر الموسيقى التقليدية، و تفتح بابا يطل منه الشاعر على الكون.
• أن تجربة الشاعر الحداثي تجربة فريدة احكمت الربط بين اللغة، و الصورة، و الإيقاع لتصبح بنية كلية هي عدة الشاعر في حواره مع المطلق، و الوجود، و الآخر، و هي وسيلته في الكشف عن اسرار النفس البشرية في تجلياتها الاشراقية بحثا عن المفقود من الامان و السلام و الطمأنينة.
• و قد تناغم الإيقاع عند الشاعر الحداثي مع الانساق اللغوية و الصورية فاعتمد على الإيقاع الداخلي الذي ينبئ عن النبض المكنون، و الهمس الباطني، إلى جانب التكثيف اللغوي، مبحرا نحو استكناه دخيلة الانسان المعاصر، في صراعه مع قوى البطش و التحدي، وسعيه لبلوغ شاطئ الاستقرار.
و بذلك تندغم الصورة باللغة و بالإيقاع لتشكل نصا جديدا قائما على علاقات جديدة بين المفردة و المفردة، الجملة و الجملة، و التركيب و التركيب.
Main Subjects
Comparative Literature
Languages & Comparative Literature
No. of Pages
241
Table of Contents
فهرس المحتويات / الموضوعات.
الملخص / المستخلص.
المستخلص باللغة الإنجليزية.
المقدمة.
التمهيد : عذابات الشاعر الحديث : في البدء كان العذاب.
الباب الأول : الأنموذج المعذب في الشعر الرومانسي.
الباب الثاني. : الأنموذج المعذب في شعر الحداثة.
الخاتمة.
قائمة المراجع.
American Psychological Association (APA)
العاني، لؤي شهاب محمود سعيد. (2005). المعذب في الشعر العراقي الحديث 1958-2000. (أطروحة دكتوراه). جامعة بغداد, العراق
https://search.emarefa.net/detail/BIM-737005
Modern Language Association (MLA)
العاني، لؤي شهاب محمود سعيد. المعذب في الشعر العراقي الحديث 1958-2000. (أطروحة دكتوراه). جامعة بغداد. (2005).
https://search.emarefa.net/detail/BIM-737005
American Medical Association (AMA)
العاني، لؤي شهاب محمود سعيد. (2005). المعذب في الشعر العراقي الحديث 1958-2000. (أطروحة دكتوراه). جامعة بغداد, العراق
https://search.emarefa.net/detail/BIM-737005
Language
Arabic
Data Type
Arab Theses
Record ID
BIM-737005