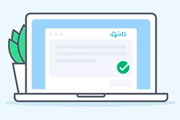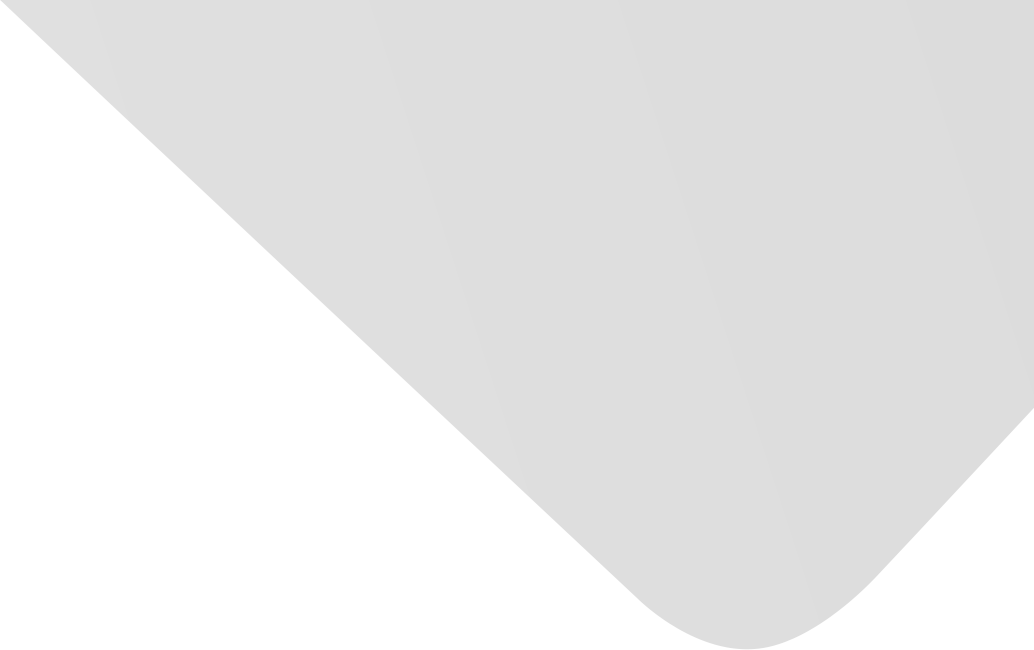
مقاربة نقدية في منهجية الدراسات الأنثروبولوجية العراقية
Other Title(s)
Anthropological methods a critical approach
Author
Source
Issue
Vol. 2017, Issue 38 (30 Jun. 2017), pp.39-66, 28 p.
Publisher
Publication Date
2017-06-30
Country of Publication
Iraq
No. of Pages
28
Main Subjects
Sociology and Anthropology and Social Work
Topics
Abstract AR
تكمن أهمية هذه البحث بمناقشة منهجية الدراسات الانثروبولوجية العراقية ومراحل نشوئها وتبلورها بالاعتماد على مرجعياتها النظرية وميادين بحثها زمانيا ومكانيا، وتأطير موضوعاتها بنماذج وظيفية، تبرز التوجهات الانثروبولوجية العراقية، وتمكننا من استجلاء وفهم طبيعة البحث الانثروبولوجي وموجهاتها النظرية والمنهج المعتمد، ومما لا شك فيه ان لكل علم من العلوم سماته الخاصة التي يتميز بها، ويميز هذه المعايير عن باقي التخصصات، إذ يحتكم إليها أهلا لتخصص في الإجرائية المنهجية (Methodological Operationalization) التي تتشكل من الموجهات النظرية وتشتغل على وفيق واعد البحث الميداني.
فقد تبنت الدراسات الانثروبولوجية العراقية نهج المدرسة البريطانية الاجتماعية الاميركية الثقافية الفرنسية البنيوية)، إن الاختلاف والتوازي والتقاطع في المدارس السابقة أفرز منهجية انثروبولوجية انعكست على موضوع الدراسات العراقية وميادينها، ومنهج التساؤل فيها.
وتمحور البحث حول مجموعة من الأسئلة التي قادتنا بالنتيجة إلى فهم طبيعة التباين بين الممارسات البحثية ومرجعياتها النظرية، وهي كالآتي: ١.
ما هي المرجعيات النظرية الأساس التي اعتمدت عليها الدراسات الانثروبولوجية العراقية في تأطير الممارسة العملية (الميدانية)، وما هي المفاهيم الحارسة التي اعتمدها الانثروبولوجيون العراقيون كموجهات نظرية للإرشاد المنهجي زمانيا ومكانيا؟ 2.
ما هو دور المكان في تقسيم وبلورة هوية الانثروبولوجي العراقي والتغيرات التي طرأت عليه، وعلاقة هذه التغيرات بالمرجعيات النظرية؟.
3.
إلى أي مدى تمتاز الدراسات الانثروبولوجية العراقية بالاستقلال عن باقي التخصصات الانسانية كالسوسيولوجيا، وهل أن التداخل والاستعارة اسهمت في تطور هذه الدراسات، أم أن هذا التداخل أفقد الباحث روح المنهج الانثروبولوجي الحقيقي العلمي؟ وبالرغم من تعدد الممكنات النظرية في علاقة الممارسة البحثية والمرجعيات النظرية، إلا أننا نرى أن الخلط والاستبدال قد ورد في العديد من أماكن الدراسات الانثروبولوجية التي تناولناها في هذا البحث.
وقام التصنيف الذي عملنا على تحديده في بحثنا هذا على فهم تطور الانثروبولوجيا العراقية التي انتقلت باطراد من دراسة المجتمعات القروية إلى دراسة الموضوعات المعقدة، في مديات تصنف ديمغرافيا على أنها حضرية، مما أدى إلى عملية تنهيج (Methololisation) المناهج المستخدمة في الدراسة لمجال مكاني وبشري وزماني بما يتوافق مع متطلبات عناوين الدراسة، وليس بما تقتضيه الموضوعية في البحث، إذ تشكل هذه الحقيقة لبالإشكالية في الاتجاهات المستعملة وبحسب المراجعة للدراسات الانثروبولوجية العراقية، يمكن القول بوجود ثلاث اتجاهات في الانثروبولوجيا العراقية يفهم من خلالها المنظار المنهجي : الأول : انثروبولوجيا القرية، إذ جاء تصنيف اغلب العناصر المنهجية لهذه المواضيع تحت عنوان المدرسة الوظيفية الانثروبولوجية الاجتماعية).
أما الاتجاه الثاني فهو : انثروبولوجيا التغير الاجتماعي، وينصب الاهتمام فيها على العنوان (المفاهيم) على خلاف الاتجاه الأول الذي يركز على المكان كدراسة أنثروبولوجية شمولية، أما الاتجاه الثالث : فيركز فيه الأنثروبولوجي ينفي دراساته مع مفهوم الثقافة، وعلى وفق المدرسة الانثروبولوجية الثقافية، وهو الاتجاه الذي أبدى فيها لانثروبولوجيون اهتماما منهجيا للدخول في الدراسات الحضرية والمجتمعات المركبة في المدنية وهو ماكان تعليه مباحث بحثنا الحالي.
وقد توصلنا الى جملة من النتائج بشأن طبيعة الدراسات الانثروبولوجية وتقاطع منهجياتها، وهي كالاتي: نتائج البحث: 1.
أن منهجية الانثروبولوجيا العراقية في بداية التأسيس (شاكر) مصطفى سليم) كانت ذات طبيعة استقرائية وحوارية بالمعنى النظري والمنهجي، ومن ثم تحولت الى استقرائية تميل إلى التكميم.
2.
يشكل البعد المكاني في الدراسات الانثروبولوجية العراقية أهمية تنعكس على منهجية الدراسة، إذن لاحظ أن مدينة بغداد حصلت على أكثر من سبعين بالمئة من نصيب الدراسات الانثروبولوجية، وهذا مؤشر خطير يتضح في جوانب عدة منها ما يخص المنهجية وتطبيقاتها في المدينة بأسلوب تقليدي، وأما الجانب الآخر فهو القصور في دراسة المجتمع العراقي ككل وفهم ثقافاته الريفية والحضرية والهامشية، بل أن دراسة الأثنيات والأبعاد الاقتصادية تحتاج إلى توسع كبير في حل العديد من الإشكاليات الموجودة حاليا.
3.
إن المنظور الكلاسيكي للبنانية الوظيفية أخذ حيزا واسعا في دراسات القرية والتغير الاجتماعي وحتى نموذج الدراسات الثقافية، والإشكالية تكمن في تركيز هذا الاتجاه على فهم كيف يتوازن المجتمع (النظرة السلوكية)، في مقابل ذلك نحتاج في مجتمعنا العراقي إلى فهم لماذا هذا التوازن التقليدي وعدمية التغير المبرمج لخلق مجتمع متجدد.
4.
إن استعمال الفرضية في الدراسات الانثروبولوجية لا يؤشر إشكالية منهجية إلا عندما يتحول الافتراض النظري إلى حكم مسبق يؤطر مسيره البحث، بمعنى أنه يتوجب على الانثروبولوجي استعمال الفروض كالية منهجية لتفسير المعطيات الميدانية، وليس كالية لرسم أو تصوير المعطيات، وقد تتحول الكثير من الافتراضات التي تحتويها مفاهيم الدراسة إلى تعاريف إجرائية كما هو موجود في بعض الدراسات المؤشرة في نموذج القرية، إذ يتخذ بعض الانثروبولوجيين افتراضا مسبقا، وعليه يتوجب معالجة هذه الإشكالية في منهجية الدراسات الأنثروبولوجية.
5.
التوسع في الجانب النظري على حساب المهمة الأساسية للبحث المتمثلة بدراسة مكان محدد أو موضوع محدد داخل سياق اجتماعي، ففي أغلب الدراسات وجدنا سبعين بالمئة من هيكل الدراسة يركز على فلسفة العلم ويتجاوز فلسفة الميدان.
6.
عدم تحرر الدراسات الأنثروبولوجية من الوصاية السوسيولوجية، إذ نلاحظ أن تراث المدرسة الأنثروبولوجية الاجتماعية نقل إلى المدرسة العراقية ومن هذا التراث توجهات بر او نفي (علم الاجتماع المقارن).
7.
في الغالب يأتي اختيار موضوع البحث على أساس مهنة الباحث، أو مكان سكنة، أو نمطه الثقافي، مما أدى إلى اختزال الخيال التحليلي بشخصية الباحث، فضلا عن ارتباط زمن المعايشة الفعلية بالمجتمع نفسه، اي ان الباحث من مجتمع الدراسة نفسه، أي عد متوفر شرط التغريب المنهجي، وهو شرط اساس لفهم المعطيات وانتاجها.
8.
تعاني معظم دراسات القرية والتغير الاجتماعي من إشكالية بناء تساؤلات إجرائية مستخلصة من المدرسة البنائية الوظيفية.
9.
التداخل في المفهوم الأثنوجرافي فعندما نتكلم عن منهج أثنوجرافي نقصد مجملا لمناهج التجريبية أو طرائق البحث ولا نكتفي بذكر منهج وصفي، وبهذا الخصوص يصبح التحدث عن منهج أثنوجرافي بالمفرد مخادعا بعض الشيء، إذ نجد أن أغلب الدراسات الأنثروبولوجية العراقية تطلق على الأثنوجرافيا منهجا وهي آلية للبحث.
١٠.
غياب ثنائية الموقع والواقعة التفاعلية في الاعمال الاثنوجرافية لنموذج القرية والتغير والاكتفاء بالمكان الشمولي، وهذا يؤكد ان معظم الدراسات الانثروبولوجية العراقية ذات طبيعة مونوغرافية ابتعدت عن الغرض من التوصيف.
11.
امتداد تأثير المفاهيم الحارسة في الدراسات الانثروبولوجية العراقية من الريف الى المدينة مع بعض التغير، مثال ذلك (شبكة العلاقات الاجتماعية في المدينة)، و(تغير السلطة الأبوية في منطقة الكرادة).
واستنتجنا من خلال ما توصلنا إليه من نتائج ان تاريخ الدراسات الانثروبولوجية العراقية وارتباطه بالممارسة الحالية للبحث الانثروبولوجي يمثل رمزي نمهمين لتقاطع المدارس البريطانية والاميركية وتداخلهما على صعيد النظرية الانثروبولوجية المعاصرة ما افرز تشطيا أثر على طبيعة الممارسة الفعلية.
وعلى أساس من هذه النتائج يمكن استخلاص أن الانثروبولوجيا العراقية - في حقيقها البحثية - لم تمارس عملية (التغريب المنهجي)، بل مارست (التغريب المجاور)، فهي بعيدة كل البعد عن انثروبولوجيات مجاورة عديدة، بل ركنت الى المرجعيات الانثروبولوجية المصرية التي تعاني اصلا من تداخلية ووصايا تسوسيولوجية كبيرة.
والإشكالية الاكثر تعقيدا وتأثرا على حقيقة البحث الانثروبولوجي العراقي، هو عدم وجود تقارير ميدانية ومذكرات عملت تابعية تعكس وتجذر الاقامة الميدانية للباحث، وهذا واضح في اغلب الدراسات الانثربولوجية العراقية.
Abstract EN
This paper will discuss the methods used in Iraqi anthropological studies, its development, function and crystallization over time.
It’s obvious that each discipline in social sciences has its own identification which play essential role in determining the methods and the implementation procedures which is usually derived from the theoretical background as well as the field.
This paper based on few questions, that leads to understand the differences between theory and practice in two ways: 1- What is the theoretical background of the anthropological studies, which has used in interpreting social phenomena? 2- What is the effects of the time and space on the process of crystalizing anthropological identity among Iraqi Anthropologists? The paper, however, pointed out some contradicted methods that recently used in this field as follow: 1- The topic appointed usually on the base of the researcher’s occupation, place of living or subculture belonging, which is simplified the problem and encourage the subjectivity view, as well as reduce the critical sensitivity.
2- The place factor has its wrong doing in most Iraqi anthropological studies, as Baghdad city alone has more than 70% of the recent studies.
The focusing on Baghdad may encourage researchers to copy each other and neglect other part of the Iraqi society.
3- The use of hypothesis in anthropological studied is a problematic issue, especially when the presumption become prejudgment, which often leads to a nasty bias and false outcomes Deductions Throughout this paper, the researcher concluded that the Iraqi anthropologists represents different theoretical approaches; on one hand one party follow American approaches and the other party follow British approaches, which in, somehow, create two contradicted way of investigating methods, nevertheless, the Iraqi anthropology is not westernized by all means, instead they often follow the Egypt ion school which is not far from the westernization impact.
American Psychological Association (APA)
حسين فاضل سلمان. 2017. مقاربة نقدية في منهجية الدراسات الأنثروبولوجية العراقية. دراسات اجتماعية،مج. 2017، ع. 38، ص ص. 39-66.
https://search.emarefa.net/detail/BIM-882531
Modern Language Association (MLA)
حسين فاضل سلمان. مقاربة نقدية في منهجية الدراسات الأنثروبولوجية العراقية. دراسات اجتماعية ع. 38 (حزيران 2017)، ص ص. 39-66.
https://search.emarefa.net/detail/BIM-882531
American Medical Association (AMA)
حسين فاضل سلمان. مقاربة نقدية في منهجية الدراسات الأنثروبولوجية العراقية. دراسات اجتماعية. 2017. مج. 2017، ع. 38، ص ص. 39-66.
https://search.emarefa.net/detail/BIM-882531
Data Type
Journal Articles
Language
Arabic
Notes
يتضمن هوامش : ص. 64-65
Record ID
BIM-882531